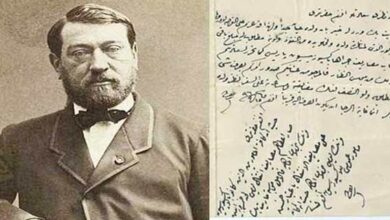مصر والغرب على أبواب الطلاق؟

من الواضح أن الغرب يجد نفسه مربكاً في التعاطي مع الملفّ المصري، ليس منذ القمع الدامي لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة في 14 آب (أغسطس) الجاري، وإنما منذ انطلاق «ثورة 25 يناير 2011». فالولايات المتحدة وجدت نفسها مرغمة على المطالبة بتنحّي الرئيس السابق حسني مبارك، بعدما رأت أن الشعب المصري، بغالبيّته الساحقة، قد نزل الى ميدان التحرير مطالباً بالتغيير. وليس بخاف أن واشنطن تنطلق في اتّخاذ قراراتها المتعلّقة بمصر من اعتبار واحد لا ثاني له، ألا وهو الحفاظ على معاهدة «كمب ديفيد» بين مصر وإسرائيل. في حين أن الاعتبارات الأخرى مثل: قضايا الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وحرّيّة التعبير، فإنها مسائل لا تحتلّ الأولوية في سلّم التعاطي الأميركي حيال مصر، وحتى حيال دول عربية أخرى، وإلا فكيف صمتت الولايات المتحدة أكثر من ستة عقود على نظام ديكتاتوري في مصر أو حتى في تونس أو ليبيا وسورية، ولم تطالب بالتغيير إلا بعد انطلاق ديناميكيّة ثورات الربيع العربي.
> بعد «ثورة 25 يناير» في مصر، واكبت واشنطن عمليّة الانتقال السياسي بالدعوة الى تسريع هذه العمليّة، ونقل السلطة من المجلس العسكري الذي تولّى الحكم من مبارك. وجرت الانتخابات الرئاسية التي أوصلت مرشّح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي الى الحكم، في حزيران (يونيو) العام 2012. ومن البديهي أن وصول المرشّح الإخواني الى الحكم، لم يكن يحظى بالرضا الأميركي الكامل، لكن أميركا لم يكن في استطاعتها تكرار السيناريو الفلسطيني، عندما ألحّت على الفلسطينييّن في العام 2006 لإجراء انتخابات تشريعيّة، وعندما فازت فيها حركة «حماس»، لم تعترف الولايات المتحدة بنتائجها. إن مثل هذا الأمر، كان سيظهر الولايات المتحدة بأنها تعادي وصول الحركات الإسلامية الى السلطة، سواء كانت معتدلة مثل «الإخوان» أو محسوبة على تيار التشدّد مثل «حماس». ولذلك اختارت أميركا التعامل مع مرسي، وبدأت عمليّة تعارف بينها وبين «الإخوان»، لا سيما بعدما بدأ مرسي ينتهج نهجاً واقعيّاً في ما يتعلق بالسياسة الإقليميّة. وتوطّـدت العلاقة الأميركية ـ الإخوانية، بعد الدور البارز الذي لعبه مرسي في التوصّـل الى وقف للنار بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة أواخر العام 2012. وترجمة للعلاقة الجديدة بين واشنطن والقاهرة في ظل حكم «الإخوان»، تمّ الاتّفاق مبدئيّاً بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، على منح مصر قروضاً بأربعة مليارات دولار. وتبع التطبيع بين أميركا و«الإخوان» تطبيع أوروبي، تمثّـل في تعهّد من الاتّـحاد الأوروبي بمنح مصر قروضاً ومنحاً بقيمة خمسة مليارات دولار، فضلاً عن تعهّد من بنك الاستثمار الأوروبي لمنح القاهرة قروضاً بمليار دولار.
وفي الوقت عينه، تكرّرت زيارات المسؤولين الأميركيين الى مصر الإخوانية على أرفع المستويات، فضلاً عن زيارات لأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب. وكان هؤلاء يركّزون في أحاديثهم مع نظرائهم المصريّين، على ضرورة أن ينفتح مرسي على قوى المعارضة، وأن لا يستفرد «الإخوان» بالحكم، لأن وجود هؤلاء في السلطة يجب ألا يعني وحدهم بالحكم. ولم تكن واشنطن راضية مئة في المئة عن عمليّة صياغة الدستور التي تفرّد بها «الإخوان» وحلفاؤهم من القوى السلفيّة، الأمر الذي وسّع الشرخ وزاد في حدةّ الاستقطاب في الداخل بين السلطة والقوى السياسية الأخرى. لكن مع عرض الدستور على الاستفتاء ونيله الغالبية المطلوبة، لم يعد في وسع واشنطن الاعتراض، مع استمرارها بالدعوة الى حوار داخلي، من أجل تسهيل عمليّة الانتقال السياسي في البلاد، واستكمال عمليّة انتخاب مجلس للنواب. وفي هذه الأثناء، كانت تـتّسع الهوّة بين مرسي وبقيّة القوى السياسية، خصوصاً مع استبداله النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين أحد المقرّبين من «الإخوان» خلفاً له، فكان الاصطدام بين مرسي والسلطة القضائيّة التي تعتبر من السلطات المستقلّة، والتي لا تدين بالولاء لأحد، حتى في عهد مبارك كان القضاء المصري بعيداً عن السياسة، ويمارس دوره باستقلاليّة الى حد كبير. ورفض مرسي أيضاً الدخول في حوار وطني، من أجل تعديل بعض مواد الدستور المشكو منها من شرائح واسعة في المجتمع، باعتبار أن الكثير من المواد صيغت بما يعطي أفضليّة لـ«الإخوان» للبقاء في السلطة. بينما كانت واشنطن تحضّ مرسي على الدخول في حوار مع معارضيه، من أجل تثبيت دعائم الحكم الديمقراطي الجديد في مصر، وللتخفيف من حالة الاحتقان السياسي التي كانت تترجم من حين الى آخر، في مواجهات في الشوارع يسقط نتيجتها الكثير من الضحايا.
ومع وصول الاستقطاب الداخلي الى حد الانفجار في 30 حزيران (يونيو) الماضي، والذي توّج في 3 تموز (يوليو) الفائت، بتدخّل الجيش لعزل مرسي من الرئاسة، ووضع خارطة طريق للمستقبل السياسي في مصر، أصيبت واشنطن بإرباك واضح، تمثّـل تخبّطاً في مواقف مسؤوليها مما يجري، هل هو انقلاب عسكري، أم أنه مجرّد تلبية لرغبة ملايين المصريين الذين نزلوا الى الشوارع في 30 حزيران (يونيو) المنصرم من أجل إسقاط مرسي؟ ولأنه ليس لدى الولايات المتحدة أي جواب واضح عما جرى في مصر، اكتفت إدارة الرئيس باراك أوباما بحضّ السلطات الموقّتة، التي عيّنها الرجل القوي في مصر وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، على تسريع عمليّة الانتقال السياسي وإجراء انتخابات جديدة. وفي إشارة الى عدم الرضا عن السيسي، أوقفت أميركا تسليم مصر أربع مقاتلات من طراز «إف ـ 16»، في حين تجاهلت النداءات الصادرة عن بعض السيناتورات الجمهورييّن المتشدّدين، مثل جون ماكين، الى اتّـخاذ إجراءات أكثر جذريّة بحق السلطات الجديدة في مصر، باعتبار أن ما جرى انقلاب عسكري أطاح رئيساً منتخباً ديمقراطيّاً. لكن الجواب المعتاد الذي يردّ به المسؤولون الأميركيّون، عندما يواجهون بالسؤال عما إذا كان ما جرى في مصر انقلاباً أم لا، فكان أن الادراة الأميركية تجري تقويماً للوضع في مصر، وعندما تنتهي من التقويم ستعلن النتيجة. بيد أن السبب من التهرّب الأميركي الرسمي، من القول صراحة إن ما قام به الجيش المصري في 3 تموز (يوليو) الفائت، يعتبر انقلاباً عسكرياً لا لبس فيه، يكمن في أن اتّخاذ مثل الموقف سيستتبع من الولايات المتحدة تعليق مساعدتها العسكرية السنوية لمصر، والبالغة ٣.١ مليارات دولار، والتي تتلقّاها القاهرة منذ التوقيع على معاهدة «كمب ديفيد» في العام 1979. ويخشى البيت الأبيض أن يترتّب على وقف المساعدة الأميركية تقصير مصري في التزام بنود المعاهدة، بما يؤثّر في أمن إسرائيل. ويقال إن جماعات الضغط الإسرائيلية طلبت من أوباما التريّث في وقف المساعدة، لا سيما أن الوضع الأمني في سيناء يشهد اهتزازاً ملحوظاً منذ إطاحة مبارك في العام 2011، وتسلّلت عناصر جهاديّة من سيناء الى إسرائيل أكثر من مرّة، وتعرّضت مدينة إيلات للقصف بالصواريخ أكثر من مرّة، وتعرّض أنبوب الغاز من مصر الى إسرائيل للنسف أكثر من 12 مرة، وتشنّ العناصر الجهاديّة التي تحتمي بقبائل محلّيّة، هجمات متكرّرة على مواقع الشرطة والجيش المصريين، الأمر الذي يجعل من شبه جزيرة سيناء منطقة خارجة على القانون، وبؤرة يلوذ بها الجهاديّون. ومثل هذا المعطى يجعل الولايات المتحدة تتريّث في وقف المساعدة السنوية العسكرية لمصر.
وبعد 3 تموز (يوليو) الفائت، استمرّ الموقف الأميركي الداعي الى الحوار بين المصريّين. وللتدليل على وجود رغبة أميركية في عدم إقصاء «الإخوان المسلمين» عن المشهد السياسي في مصر، قام نائب وزير الخارجية الأميركي وليم بيرنز بمقابلة مرسي في مكان احتجازه، في مسعى أميركي من أجل إيجاد مخرج للأزمة، وتجنّب حمّام الدم، والدفع بمصر نحو حالة من عدم الاستقرار. كما كلّف أوباما كلاً من جون ماكين والسيناتور ليندسي غراهام بزيارة مصر، والتقاء مختلف الأفرقاء السياسييّن بمن فيهم مرسي. إلا أن الوساطة الأميركية التي كانت تسير أيضاً على خط مواز، عبر اتّصالات يجريها وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل بالسيسي، اصطدمت بحائط مسدود، مثلما لاقت المصير نفسه الوساطة التي قامت بها الممثّـلة العليا للاتّـحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنيّة كاترين آشتون ووزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفله. فـ«الإخوان» تمسّـكوا بمطلبهم إعادة مرسي الى منصبه، بينما الحكومة الموقّتة مدعومة من السيسي تمسّـكت بخارطة الطريق التي وضعتها في 3 تموز (يوليو) الماضي، الى أن كان الصدام الدموي في 14 آب (أغسطس) الحالي، يوم قرّرت السلطات الموقّتة فضّ الاعتصامين في رابعة العدوية والنهضة بالقوّة، مما أسفر عن مقتل المئات وجرح الآلاف.
وردّاً على عمليّة الاقتحام الدامي، اتّخذت واشنطن موقفاً متشدّداً عبّر عنه أوباما، بالاعلان عن تعليق مشاركة الولايات المتحدة في مناورات «النجم الساطع»، التي تجرى كلّ عامين بالاشتراك مع جنود مصريين. وكان الانزعاج الأميركي واضحاً من الاقدام على اقتحام مكاني الاعتصامين، في عمليّة وضعت مصر على قدم وساق مع الصين، عندما أقدمت على قمع تظاهرات تطالب بالديمقراطية في ميدان تيان آن مين (السلام السماوي) في بكين العام 1989. واستجرّ القمع الصيني عامذاك عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وعزلة دولية استمرّت سنوات.
لكن واشنطن، على رغم القمع الدامي، لم تصل الى حدود تعليق المساعدة العسكرية السنوية لمصر، لربما كي تحافظ على خط ارتباط مع الجيش المصري من جهة، ومن جهة ثانية كي لا يدفع وقف المساعدة بالمؤسّسة العسكرية المصرية، الى إعادة النظر في علاقة الصداقة مع الولايات المتحدة، والبحث عن حلفاء دوليّين جدد، في وقت عادت فيه روسيا الى البروز في الأعوام الأخيرة كقوّة إقليميّة يحسب لها الحساب، ومستعدّة لمنافسة الولايات المتحدة مجدّداً، بما يذكّر بأيام الحرب الباردة.
وبكلام آخر، لا تريد واشنطن الذهاب في مواقفها من مصر الى حد القطيعة النهائيّة، كي لا يترتّب على ذلك مواقف مصرية مماثلة تدفع بالقاهرة الى إعادة النظر، سواء في التزاماتها الإقليميّة أو الدولية. وفي الوقت عينه، يمثّـل التعامل مع الحكومة المصرية الموقّتة بحكم الأمر الواقع، تنازلاً أميركياً عن مجمل القيم التي تنادي بها من أجل الحكم المدني وترسيخ الديمقراطية ليس في مصر فحسب، وإنما في بقيّة أنحاء المنطقة. ومعلوم أن ما يجري في مصر سيؤثّر حكماً في العمليّة السياسية في تونس وليبيا، وحتى في المعارضة السورية التي تخوض حرباً لإسقاط نظام بشار الأسد.
وفي المحصّـلة، يبدو أن الغرب عموماً والولايات المتحدة خصوصاً، سيكونان محكومين بالتعامل مع مصر، كما هي وليس كما يتمنّيان أن تكون >
المصدر«المشاهد السياسي» ـ لندن