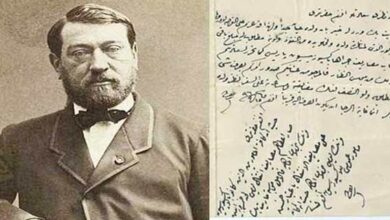صحيفة أمريكية: بندر بن سلطان هو كبير الجواسيس بالشرق الأوسط؟

نشرت صحيفة “ذا ديلي بيست” الأمريكية مقالاً وصفت فيه رئيس جهاز الاستخبارات السعودي بندر بن سلطان بأنه “كبير الجواسيس في منطقة الشرق الأوسط”، مشيرة الى أنه “يهدف حالياً الى سحق جماعة الاخوان المسلمين رغم أنها مجموعة سنية”، ولفتت الى أنه في حالة “تحالف مع “اسرائيل” رغم أن لا معاهدة سلام بين “تل أبيب” والرياض حتى الان”.
وجاء في الصحيفة: بعد أن كان مشهوراً في واشنطن بسيجاره وحفلاته وسحره، غدا الأمير بندر بن سلطان الآن يقاتل إيران في سوريا ويندد بإدارة أوباما.
حينما كان الأمير سفيراً لبلاده في واشنطن، كم دارت حوله الأنخاب. وكم دخن بندر بن سلطان من السيجار الفخم وكم احتسى من الكونياك الأكثر فخامة. على مدى ثلاثين عاماً قضاها مرسالاً للملكة العربية السعودية ومدافعاً عن مصالحها وسفيراً لها، كان بندر يقص حكايات مدهشة حول السياسيين والملوك، كان بعضها، ويا للمفاجأة، حقيقياً. لقد أحبه صحفيو واشنطن، فلا أحد كان يضاهيه في علاقاته بأصحاب النفوذ في المواقع العليا، ولا أحد مثله كان يأتي بالأموال الطائلة ليوزعها بهدوء بكميات كبيرة ليساعد أصدقاءه.
كان بندر قد رتب عبر السنين تخفيضات في سعر النفط العالمي خدمة لجيمي كارتر ورونالد ريغان وبوش الأب وبوش الإبن. كما رتب بأمر من مدير السي آي إيه بيل كيسي، ومن وراء ظهر الكونغرس، تمويل حروب ضد الشيوعية في نيكاراغوا وأنغولا وأفغانستان. كان على علاقة حميمة بديك تشيني ومقرباً جداً من عشيرة جورج إتش دبليو بوش، أباً وأماً، وأبناءً وبنات، حتى أنه بات يدعى “بندر بوش”.
بندر بن سلطان
أما الآن، فقد أصبح الأمير جاسوساً، أو، بشكل أدق، كبير الجواسيس في الشرق الأوسط. إنه رأس الحربة في برنامج سعودي واسع من العمل السري والإنفاق الواضح الذي أسهم في الإطاحة بالحكومة المنتخبة للإخوان السلمين في مصر ويسعى إلى تشكيل “جيش إسلام” جديد في سوريا. دون فهم هذا الرجل وفهم مهمته، فلا سبيل في الحقيقة إلى فهم ذلك الذي يجري في أكثر مناطق العالم اضطراباً في الوقت الحالي.
هدف بندر هو إضعاف قوة إيران من خلال سلخ حلفائها بشار الأسد وحزب الله عنها، والحيلولة دون أن يحصل ملالي إيران على الأسلحة النووية، وإحباط مخططاتهم في المنطقة، وخلعهم من الحكم إذا وجد إلى ذلك سبيلاً.
كما يهدف في نفس الوقت إلى سحق جماعة الإخوان المسلمين، تلك المنظمة السنية التي تتظاهر بالدفاع عن الديمقراطية وفي نفس الوقت تناهض الأنظمة الملكية بقوة.
تتخلل برنامج بندر بعض التحالفات المثيرة للاهتمام. فبغض النظر عن عدم وجود معاهدة سلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وحسبما يرددون هنا في هذه المناطق كل حين من “أن عدو عدوي هو صديقي”، فقد أصبح بندر في الواقع العملي حليفاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العداوة لإيران. يقول عن ذلك المؤرخ روبرت ليسي صاحب كتاب “داخل المملكة: ملوك ورجال دين، حداثيون وإرهابيون، والنضال من أجل العربية السعودي”: “لقد باتا متحدين، الأمر الذي يبعث على الفضول”. لقد كان بندر دوماً نزاعاً نحو تحدي الأعراف والالتفاف حول القواعد”، أو كما يقول ليسي” “بندر إنسان لا يخجل ولا يخشى”.
وكأنما يكرر ما يقوله نتنياهو من حين لآخر أراد بندر في الشهور الأخيرة أن يكون معلوماً لدى الجميع بأن أكبر عقبة تعيق تحقيق أهدافه هو الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وينقل عن بندر أنه أخبر بعض الدبلوماسيين الأوروبيين الشهر الماضي أن المملكة العربية السعودية قد تقوم بـ “نقلة كبيرة” لتنأى بنفسها بعيداً عن تحالفها القائم منذ زمن طويل مع الولايات المتحدة الأمريكية.
بعض السعوديين من رفقاء بندر ومعارفه قالوا إنه إنما قصد التنفيس عن غضبه، إلا أن بعض متابعيه عن قرب والمطلعين على شؤون عمله يظنون بأن جزءاً من النقلة التي تحدث عنها قد يكون محاولة توطيد علاقة أكثر حميمية مع باكستان المتسلحة نووياً.
فرئيس وزراء باكستان نواز شريف، الذي انتخب مؤخراً، كان قد عاش في حمى العائلة الحاكمة في العربية السعودية طوال العقد الماضي تقريباً. في عام ٢٠٠٩ تنبأ الصحفي والأكاديمي دافيد أوتاوي، مؤلف السيرة الذاتية للأمير بندر بعنوان “رسول الملك” بأنه: “إذا أصبحت إيران قوة نووية وهددت المملكة فإن باكستان يمكن أن تغدو الحامي الأساسي لها والمدافع عنها بدلاً من الولايات المتحدة.” وفي أكتوبر، صرح يزيد صايغ، الباحث بمركز كارنيغي للشرق الأوسط، بأن السعوديين يحاولون إقناع الباكستانيين بإعداد برنامج تدريب واسع لثوار سوريا.
يمكن، بالطبع، نسبة كثير من ذلك إلى حالة الإحباط التي يشعر بها السعوديون تجاه أوباما، الذي جازف مراراً وتكراراً خلال السنوات الأخيرة بموارد ومكانة المملكة العربية السعودية دون مردود يذكر. فسوريا ماتزال كارثة غارقة في الدماء على مسافة قصيرة من البوابة السعودية. وها هو العراق ينزلق بشكل مستمر نحو هاوية الحرب الطائفية بين الشيعة (المدعومين من قبل إيران) والسنة (المدعومين من قبل السعودية). كما أن النزاع المدني المستمر في مصر والانهيار الاقتصادي فيها حول البلاد إلى حفرة بلا قرار تبلع المليارات من الدولارات السعودية. ولكن، وبالرغم من وجود الكثير مما يمكن بسببه تخطئة سياسة أوباما، لا ينبغي أن ينظر إلى الأمر كما لو أن بندر والسعوديين مجرد متفرجين أبرياء.
لقد قضى الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي لا يقل عمره الآن عن تسعين عاماً، حياته وأنفق ما لا يحصى من المليارات من الدولارات في محاولة لنشر الاستقرار في المنطقة. إلا أنه لم يجن ثمار ما دفع من أجله. فقد صعق الربيع العربي السعوديين وأرعبتهم حالة الفوضى التي عمت المنطقة نتيجة لذلك، ولم يجدوا حتى هذه اللحظة الوسيلة الفعالة لاستعادة الهدوء.
حتى في لبنان الصغير، تمكن الإيرانيون وحلفاؤهم في حزب الله من سحب البساط من تحت أقدام السعوديين وتغلبوا عليهم وعلى رجالهم. حينما تخلى بندر عن موقعه كسفير لبلاده في واشنطن عام ٢٠٠٥، استلم منصب مستشار الملك للأمن القومي، تلك الوظيفة التي تفتقر مهام صاحبها إلى تعريف واضح المعالم. كانت إحدى أولى مهامه في ٢٠٠٦ هي تشجيع الإسرائيليين سراً بالمضي قدماً في حربهم الضروس ضد حزب الله في جنوب لبنان. إلا أن حزب الله دافع عن نفسه فارضاً على الإسرائيليين الانسحاب. صحيح أنه خرج من الحرب مضرجاً بالدماء إلا أنه لم يركع وخرج بمصداقية أكبر بكثير مما توفر له في أي وقت سابق.
كانت رؤية بندر للبنان حتى تلك اللحظة منحرفة بشكل عجيب حتى إنه دعم، ولفترة ما، ترشيح سمير جعجع، القائد السابق للكتائب المسيحية المارونية المتوحشة، لمنصب الرئيس القادم في البلاد. بعض أمراء الحرب اللبنانيين الآخرين الذين عملوا مع بندر يشتكون من أنهم لم يعودوا يتمكنون من الوصول إلى رئيس الاستخبارات السعودي عبر الهاتف. وكأنه يختفي لعدة أيام كل حين. ويقولون في بيروت بأن ملك السعودية عبد الله لم يعد يحب سماع كلمة “لبنان” تلفظ في حضرته.
يقول مصدر لبناني مقرب من كثير من المفاوضات التي تجري في الغرف السرية في المنطقة طلب عدم الإفصاح عن هويته: “ليست المملكة العربية السعودية على ما يرام، ومقياس ذلك هو حالة الهلع التي أصابت المملكة إثر التقارب الأمريكي – الإيراني”.
“النقلة الكبيرة” في العلاقة مع أمريكا لم تأت لأن بندر أو حتى الملك عبد الله هو الذي قرر إحداث خضة وإعادة ترتيب الأمور، وإنما لأن المملكة العربية السعودية لم تعد حيوية بالنسبة للولايات المتحدة كما كانت من قبل. لقد شهدت الأعوام العشرة الماضية تغيرات ضخمة في توريدات الطاقة حول العالم، الأمر الذي لم تعد معه المملكة العربية السعوية ولا منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيك) التي كان يهابها الجميع تملك السلطة التي كانت تتمتع بها قبل أربعين عاماً. فبفضل التقنيات الحديثة لاستخلاص الغاز الطبيعي من طبقات الأرض الصخرية العميقة غدت الولايات المتحدة الآن أكبر منتج في العالم للهيدروكربونات (النفط والغاز)، كما أصبحت التوريدات النفطية حول العالم من خارج مجموعة الأوبيك تشكل نسبة أكبر بكثير من تلك التي تشكلها صادراتها.
في عام ١٩٧٣ أعلن الملك فيصل حظراً على تصدير النفط إلى الغرب، الأمر الذي صعق الولايات المتحدة وهز أركانها الاقتصادية وأحدث تحولات مهمة في الاقتصاد العالمي. واليوم، يعبر السعوديون عن حنقهم من خلال نوبات غضب دبلوماسية لا قيمة لها. بل، لعل العالم لم يلق لهم بالاً حينما رفضوا الحديث في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أو حينما أعلنوا قبل أسابيع بأنهم سيرفضون تسلم أحد المقاعد غير الدائمة في الدورة القادمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
يقول ليسي: “طبعاً، السعوديون غير سعيدين، ولكن الأمور اليوم تختلف عما كانت عليه عام ١٩٧٣”.
لابد أن بندر، حقيقة، يتمنى لو أن الأيام السعيدة الأولى تعود من جديد. فخلال ٢٢ عاماً قضاها سفيراً للملكة في واشنطن، وحتى قبل ذلك، كان عمله يتركز في صميم أحداث العالم.
رغم ما يحمله من لقب، وبالرغم من موقع والده الراحل كوزير للدفاع لسنوات طويلة ثم كولي عهد محتمل، حينما كان الأمير بندر صغيراً ويعيش في الرياض لم يكن في الحقيقة جزءاً من الطبقة العليا في المجتمع السعودي. فأمه كانت خادمة (والبعض يقول أمة) سوداء البشرة حملت به من والده حينما كانت في السادسة عشرة من عمرها. ولذلك، فبندر لم ينعم بأي من الأبهة أو المكانة التي كانت أمهات الأمراء الآخرين المحظيات يجلبنها لأبنائهن في المملكة. لكنه كان ذكياً جداً، يتحدث الإنجليزية بطلاقة منقطعة النظير، وطياراً حربياً بأعلى المؤهلات، أحاط علماً بكافة المسالك المؤدية إلى القادة العسكريين في الولايات المتحدة الأمريكية.
لقد لعب بندر دوراً مهماً في السبعينيات من القرن الماضي في إقناع الكونغرس الأمريكي بعدم الانصياع إلى الاعتراضات الإسرائيلية على بيع الولايات المتحدة للعربية السعودية طائرات مقاتلة في صفقة قيمتها عدة مليارات من الدولارات. فيما بعد أصبح بندر مرسالاً ووسيلة تواصل بين الرئيس جيمي كارتر وولي العهد الأمير فهد بن عبد العزيز الذي كان حينها الحاكم الفعلي للسعودية.
كان الأمير فهد يدرك جيداً التناقضات الأساسية في العلاقة بين “أرض الأحرار” و “بيت آل سعود”. قد تكون الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم بينما السعوديون هم أكبر مصدر لها، إلا أنه فيما عدا ذلك فقليلاً ما تلتقي المصالح. حسبما يرويه باتريك تيلر في كتابه الرائع “عالم من القلاقل: البيت الأبيض والشرق الأوسط – من الحرب الباردة إلى الحرب على الإرهاب” كان فهد قد قال لبندر الشاب: “الولايات المتحدة هي أخطر شيء علينا. ليس لدينا ارتباط ثقافي بهم، ولا ارتباط عرقي، ولا ارتباط ديني، ولا ارتباط لغوي، ولا ارتباط سياسي”.
كانت العلاقات الشخصية والخدمات الكبيرة هي العامل الأهم في الإبقاء على الروابط بين البلدين، وكان بندر هو الرجل الذي على يديه تنجز كل هذه الأمور. كانت حفلاته المسائية أسطورية، أشبه ما تكون بحفلات “غاتسبي العربي” كما يقول تيلر. ومن خلف الستار، كما بدا للمراقبين، لم يكن ثمة ما يمتنع عن فعله في سبيل تعزيز محور واشنطن – الرياض.
جاء وقت الحصاد حينما غزا الدكتاتور العراقي صدام حسين الكويت عام ١٩٩٠، مهدداً بشكل خطير، في نفس الوقت، المملكة السعودية. كان بندر هو الذي مهد الطريق أمام الولايات المتحدة لتنزل قواتها في بلاده وتشن من هناك عملية عاصفة الصحراء التي أخرجت صدام من الكويت وأزالت الخطر المحدق بالمملكة.
بعد أقل من عقد واحد، وتحديداً في صائفة عام ٢٠٠١، كان ولي العهد عبد الله قد ابتعث بندر إلى واشنطن ليخبر الرئيس جورج دبليو بوش الذي كان قد استلم منصبه للتو بأنه آن الأوان لمبادرة أخرى كبيرة تتضمن الاعتراف بحق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولة خاصة بهم وإنهاء القتل في الأرض المقدسة. وكلف بندر أن يقول للرئيس بوش أن الأمور ستسوء بشكل كبير إذا لم يتحقق ذلك.
مرة أخرى، كان هناك كلام عن أن الرياض قد تستخدم “سلاح النفط”. وافق بوش على الإقرار بأنه في نهاية المطاف لابد أن تقوم للفلسطينيين دولة منفصلة وقابلة للحياة. إلا أنه، وبينما كان البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية يعكفان على إعداد مسودة للإعلان، اختطف ١٩ إرهابياً طائرات استهدفوا بها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) وحقلاً في بنسيلفانيا، وكان ١٥ منهم سعوديين، شكلوا “العضلة” التي أنزلت الرعب في قلوب ركاب الطائرات.
كنت قد رأيت بندر بعد الحادثة مباشرة حين قابلته في قصره الكائن في ضاحية نيلي سوغ سين على أطراف باريس (وهو واحد من مقرات إقامة كثيرة له حول العالم)، وتظاهر حينها بالشجاعة. إلا أنه، وبوضوح، لم يكن يعرف ماذا يقول. فالدليل على أن مواطنين سعوديين كانوا متورطين كان دليلاً دامغاً لا سبيل إلى دحضه، وقد فشلت الأجهزة الأمنية السعودية في تحريهم أو تقصي تحركاتهم.
بعد ذلك، بدأت إدارة بوش في الإعداد لحرب جديدة على العراق، وحذر بندر من تداعياتها، إذ كان السعوديون يعلمون بأن النتيجة الحتمية لإسقاط صدام هي تقوية إيران، وهذا ما حدث فعلاً. تارة أخرى، رفع السعوديون معدلات إنتاج النفط حتى لا ترتفع أسعار الوقود في محطات تزويد المواطنين داخل الولايات المتحدة بشكل مؤذي: وهي خدمة حيوية قدمها السعوديون للرئيس بوش. يقول ليسي: “ولكن، إذا كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد أجهضت الخصوصية التي كانت تتميز بها “العلاقات الخاصة” بين السعودية وأمريكا، فإن غزو العراق قضى عليها قضاءً مبرماً”.
وحتى بعد أن غادر بندر موقعه كسفير لبلاده في واشنطن في عام ٢٠٠٥، فقد استمر في نقل الرسائل من الرياض إلى واشنطن وبالعكس. بدا واضحاً بشكل متزايد، مع ذلك، أن العالم وعالمه هو قد تغيرا. فبسبب آلام مزمنة في الظهر تعود إلى حادثة تحطم طائرة كان يقودها حينما كان طياراً إضافة إلى مشاكل صحية أخرى، لم يسلم بندر – الذي لم يكن يعرف التعب – من الإرهاق. فرغم أنه في مطلع الستينيات من عمره إلا أنه يبدو الآن أكثر هرماً.
في العام الماضي، وبحسب أشخاص عملوا عن قرب معه، أخبر بندر الملك عبد الله بأن بإمكانه حل المشكلة في سوريا خلال شهور. لم يفلح قبل ذلك رئيس الاستخبارات السابق وأخو الملك غير الشقيق الأمير مقرن في تحقيق الكثير من التقدم في هذا المجال. إلا أن بندر، كما ثبت، لم ينجز الكثير أيضاً.
يقول أحد السعوديين الذين تعاونوا مع بندر عن قرب: “وظيفته تتطلب أن يكون قادراً على العمل ١٨ ساعة في اليوم، ولكن ذلك ليس بوسعه”. لقد بات محبطاً وغاضباً وتواقاً لأن يستعرض أمام العالم قدرته على إنجاز ما يبدو مستحيلاً، كما كان يفعل في الماضي. ولكن، وكما يقول نفس السعودي الذي عمل معه: “ليس جيداً في مجال الاستخبارات أن يكون المرء غاضباً”. واليوم، لم تعد صفة “عدم الخجل وعدم الخشية” تكفي.