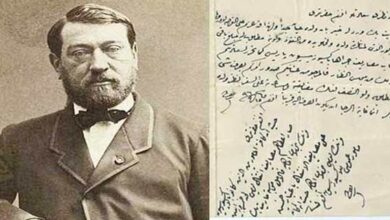مستقبل النظام الدولي بعد جائحة كورونا علي الصعيد الامني

بقلم : الدكتور عادل عامر
الصعيد الدولي: أما على صعيد العلاقات الدولية وبنية النظام الدولي فمن المتوقع أن يتمحور الاهتمام على قضيتين أساسيتين هما:
(1) الحمائية مقابل الاعتمادية: نحن نعيش الآن في عالم معولم، منفتح على التجارة الحرة وانسياب الأفراد بدرجة عالية من الحريّة. وأساس الاقتصاد العالمي الآن هو التخصصية وتقسيم العمل بين جهات متعددة، ما يعني أن سلاسل التوريد ممتدة وقاطعة للحدود. ما يُستهلك في مكان على الأغلب أن يكون أُنتجَ في مكان آخر، ومن خلال عملية تجميع تكاملية لأجزاء قد تكون مصنّعة في أماكن مختلفة أخرى.
لقد أدت محنة مواجهة وباء الكورونا حتى الآن إلى إغلاق حدود الدول على بعضها البعض، وايقاف جلّ حركة التنقل، وخصوصاً بالطائرات، وتقليص كبير في حجم التجارة الدولية. لقد انكفأت الدول على ذاتها،
وبدأت بحصر اهتماماتها بتأمين أمن مجتمعاتها، ما عزّز التوجهات القومية الانغلاقية على انفتاحيه العولمة التي كان العالم معتاداً عليها حتى الآن.
مع هذا التحوّل بدأت تبرز نزعات أنانية تؤْثر المصلحة الذاتية للدول على أهمية التعاون فيما بينها. هذا ما يُستدل عليه من محدودية المساعدة الأوروبية لإيطاليا على سبيل المثال. فقد أصبح متداولاً ومقبولاً أن كل دولة عليها الاهتمام بنفسها،
والاحتفاظ بمقدراتها درءاً واستعداداً للمجهول الذي قد يطرأ عليها في المستقبل. فمنذ الآن ستصبح إمكانية انتشار جائحة وبائية جديدة في المستقبل أمراً محتملاً يدخل في حسابات الدول واستعداداتها للطوارئ المستجدّة.
سيحتدم في مستقبل الأيام النقاش بين أطراف سياسية ذات توجهات مختلفة، وفي دول عديدة، خاصة الدول الكبرى، حول الجدوى من المسارين: هل الأفضل الانغلاق على الذات، أم استمرار الاعتمادية والانفتاح على الغير؟
ستركز وجهة النظر الأولى على أهمية وضرورية الاهتمام بالذات، إذ اثبتت المحنة الحالية أن التعويل على الآخرين ليس مضمون النتائج. سيؤكد أصحاب هذا الموقف على ضرورة حماية الدولة وحدودها، وتقليص الهجرة لها إلا بشروطها ولمصلحتها.
وقد يذهب الأمر حتى إلى الطلب من الزائرين لها إبراز شهادات طبية معتمدة قبل السماح لهم بالدخول إلى أراضيها. وسيصّر هؤلاء إلى ضرورة العودة إلى هيكلة الاقتصاد ليتمركز قدر الإمكان في الداخل، لتقليص سلاسل التوريد إلى الحدود الدنيا.
وسيدفع هؤلاء بفكرة ضرورة الاحتفاظ بمخزون من الاحتياجات الاستراتيجية، وتصنيعها محلياً كي لا تقع الدولة أسيرة لغيرها.
وبالطبع، سيكون متوقعاً أن يدعم أصحاب هذا التوجه الانعزالي تقنين المشاركة في الهيئات الإقليمية والدولية، وفي مساعي حلّ النزاعات على هذين الصعيدين، وسيدعون إلى تخفيض المساعدات الدولية،
وتقليص العون للدول الهشّة. باختصار، من الممكن أن تزداد قوة القوى المناهضة للعولمة، وأن يتصاعد نفوذ الشعبوية واليمين المتطرف في أرجاء متعددة من العالم. بالمقابل، سيُصّر مؤيدو الانفتاح على العالم الخارجي على ضرورة استمرار هذا التوجه، بل وسيؤكدون على أن الأمر لم يعد خياراً متاحاً للدول.
فالعولمة أصبحت أمراً نافذاً ومقضّيا، ومن يعزل نفسه، بالنسبة لهم، سيكون من الخاسرين. فبُنية الاقتصاد الدولي وتركيبة العلاقات الدولية أصبحت اعتمادية متداخلة على بعضها البعض، ولا يمكن، ولا يوجد أي استفادة، من محاولة إعادة العجلة إلى الوراء. بل العكس،
فإن التعاون الدولي أصبح أكثر أهمية وضرورية جرّاء ما يمّر به العالم من كوراث طبيعية وجوائح وبائية. وستجد الدول أن قدراتها الذاتية، مهما تعاظمت، ليست كافية لوحدها لمواجهة هذه الكوارث والجوائح، وأن عليها الانفتاح على بعضها، ومساعدة بعضها البعض للنجاح في تخطي الأزمات. فما يصيب دولة هشّة،
مثل انتشار وباء فيها، سيصل بالتأكيد إلى دول أقوى منها، إذ لا حصانة مضمونةً لأحد. هذا ما أثبتته محنة العالم بوباء كورونا. وسيُصّر هؤلاء على أن قضايا دولية مثل الانحباس الحراري والهجرة والتسلح وانتشار الأمراض والأوبئة يجب معالجتها بالتضامن والتكاتف الدولي، مع المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية. فالعالم المفتوح على بعضه لا يمكن ولا فائدة تُرجى، من إعادة إغلاقه.
(2) انتقال مركز النظام الدولي نحو الشرق: سنجد من آثار محنة العالم حالياً أن الولايات المتحدة، بنزعة ترامب العدائية، تراكم الخسارات على الصعيد الدولي، وتشهد تراجعاً في مكانتها المتصدرة حالياً للنظام الدولي أحادي القطبية. بالمقابل،
فإن الصين تراكم نجاحات في سجل علاقاتها الدولية. وما المساعدات الطبية التي تقدمها حالياً لدولٍ أخرى، مثل إيطاليا وصربيا، إلا دليل على ذلك. يبدو أن الصعود الصيني المستمر على الواجهة الدولية سيأخذ دفعةً إيجابية من المحنة العالمية الحالية،
وقد يعزز من مكانة الصين الدولية. فالنظرة من الخارج للصين إيجابية وتزداد إعجاباً بالتصرفات الصينية على الصعيدين الداخلي والخارجي معاً. وهذا الرصيد المتصاعد سيدعم موقع الصين ومن الممكن أن يُسرّع من تحوّل النظام الدولي إلى التعددية القطبية،
إن لم يكن إلى الثنائية القطبية. سيولي المتخصصون في مجال العلاقات الدولية اهتماماً خاصاً لمتابعة هذه الإمكانية. رغم أنّه قد يكون مُبكراً تقييم الآثار الأمنيّة الإقليميّة لـ«كورونا» على منطقة الشرق الأوسط، ينظر المُراقبون إلى بداية انتشار الوباء باعتباره الحدث الأجدّ ضمن سلسلة الصدمات التي هزّت الشرق الأوسط على مدى العقدَين الماضيين.
إذ أنّ الغزو الأميركي للعراق، والانتفاضات العربيّة، والحروب الأهلية في سوريا واليمن وليبيا، وظهور «داعش» وزواله، قد جعل بلدان المنطقة في تصنيف الدول الفاشلة. يضاف إلى ذلك، الصراعات الإقليميّة، والكوارث الإنسانيّة، وأزمة الشرعيّة في أنماط الحكم السائدة في المنطقة.
من المتوقع أن يؤدي انتشار «كورونا» على الأقلّ، إلى تنامي هذه الديناميت، كما سيشكّل اختبارا قاسيا لمرونة وقدرة صمود ليس فقط دول المنطقة على الصعيد الفردي إنمّا النظام الإقليمي ككلّ.
إنّ المهمّة المعقّدة لإدارة الجوانب السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة للأزمة ستشكلّ تحدياً كبيراً لحكومات الدول الإقليميّة، التي إذا فشلت في إدارتها لهذه الأزمة ستواجه أزمة شرعيّة.
كما أن هناك اعتماداً كبيراً على قدرة أنظمة الصحّة العامّة في المنطقة على مواجهة الأزمة، علما بأن الكثير من بين هذه الدول سجّل مستوى أقلّ من المتوسط في مؤشر الأمن الصحّي العالمي.
سيكون تأثير الوباء أكثر حدّة في الدول الضعيفة أو الدول التي توشك على الانهيار إذ أنّها تقع في صميم محاور الصراع المتعدّدة داخل المنطقة. وهذا سيغذي حتما حلقة مفرغة من الصراع، واحتمال تجدّد موجات الإرهاب والتمرّد، والتدخّل الإقليمي، الأمر الذي سيؤدّي بدوره إلى خسائر فادحة لدى السكّان في مناطق الصراع المنكوبة.
كل هذا سيزيد، بلا شك، من الضغط على البيئة الأمنيّة الإقليميّة المجهدة أصلاً. لكن رغم ذلك، تقدّم الأزمة فرصة لتقليل التوترات الإقليميّة.
إن عرض دول عربية تقديم المساعدة الطبية وغيرها لإيران وتأييد السعودية وقف النار الذي أعلنته الأمم المتحدة في اليمن من أجل التصدّي لتفشي الفيروس، يقدّم دلائل على وجود الأمل في أنّ الشرق الأوسط يمكنه على الأقلّ،
أن يقلل من تأثير هذه الصدمة الأخيرة للنظام الإقليمي. إن حوالي 90 في المائة من سكان الإقليم يعيشون في الدول ذات دخل متوسط وضعيف ما يتسبب في ضغوطات مالية على النظم الصحية التي تشكو من نقص التمويل وعدالته أصلاً.
كما تجدر الإشارة إلى أن إقليمنا يأوي أكبر عدد من اللاجئين والمهجّرين الذين يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية غاية في الصعوبة.
إن الدروس الأولية المستخلصة من تجارب الدول في التعامل مع هذه الجائحة أبرزت قوّة وسرعة انتشار الوباء حتى تجاوز في بعض البلدان الغنية مثل إيطاليا وفرنسا الإمكانيات المتاحة، ويهدد في حال عدم تراجعه بانهيار المنظومات الصحية بكاملها.
كما وقع التركيز على الاستراتيجيات الاستباقية للتعامل مع الوباء وتطوير آليات المشاركة الفردية والمجتمعية في الوقاية وتعزيز الصحة، من أجل تفادي الضغوطات الكبيرة على الخدمات العلاجية، بخاصة في ظروف ندرة الموارد المادية والبشرية.
أما على المستوى الإقليمي، فأظهرت هذه الجائحة الصحّية أهمية الاستثمار في البنية الصحّية وفي تقوية النظم الصحّية لتطوير الاستجابة للحاجات المستجدة والتعامل مع الأوبئة العالمية. وأثبتت أهمية الوظيفة الاجتماعية للدولة المتمثلة في حماية الأمن الصحي وكذلك الدور المحوري للقطاع الصحي العمومي نظرا لشموليته وقلّة العراقيل المالية للحصول على خدماته مقارنة بالقطاع الخاص.
يحدو الأمل الجميع في تحويل الوباء إلى فرصة متاحة لدول الإقليم لتطوير التآزر والتضامن بينها في الميدان الصحي وفي السعي نحو دعم الاستثمار في التنمية الصحية ونحو تحقيق هدف التغطية الشاملة بنظم صحية عادلة تحقق الهدف النبيل للصحة للجميع.
من جائحة بيولوجية تحت المجهر على مقياس نانوميتر إلى جائحة أمنية على قياس العالم، استهدف فيروس “كوفيد-19” المعروف باسم فيروس كورونا “التاجي” المتجدد، الإنسان، ووجد في كل دولة بيئة حاضنة له من دون تمييز بين شرق وغرب، بين عالم شمال وعالم جنوب، دول متقدمة أو أخرى نامية؛ متخطيًا بذلك كل معايير التقسيم الجيوسياسية، ومتربعاً بعرش الأمن الصحي الإنساني على سائر أطر الأمن والدفاع الاستراتيجيين.
فلمّا كانت الدول قد اعتادت تركيز قدراتها الدفاعية ومقدّراتها المالية على التصدي للتهديدات الخارجية العسكرية التي تمسّ بأمن الدولة السيادي بالدرجة الأولى، كشف هذا الوباء أن التهديد الذي يطال المواطنين لا يقل أبداً أهمية عن الذي يهدد سيادة الدولة؛ حيث أنّ الشعب هو المكوّن الرئيسي للدولة، وحماية الإنسان تعلو على السيادة ولا يعلى عليها.
أمام سرعة تفشّي الجائحة المميتة، أفشى فيروس كورونا المتجدد عن مكامن الضعف الخفية للدول، المستترة خلف رداء نظري من القوة ومن الحماية التي تكفلها الدولة لمواطنيها. لقد فرض الوباء وسرعة انتشاره على العالم عزلة داخلية وخارجية،
حتى أن مهمة الجيوش الوطنية الأولى أصبحت محصورة في فرض الإقامة الجبرية على السكان داخل البيوت منعا للاحتكاك بهدف تقليل الإصابات بعد أن عجزت الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي عن استيعاب المصابين.
ولعلّ أخطر ما كشفه الوباء على مستوى الأداء السياسي للدول، سوء تقدير معظم الحكومات للأزمة والاستهتار بخطورتها، وبالتالي سوء إدارتها والتقاعس عن فرض الحجر الفوري للسكان والإقفال العام لمرافق الدولة ومؤسساتها، وصولًا إلى الحذر من إعلان حالة الطوارئ والتردد أمام توصيف هكذا قضية صحية وطنية خطيرة بأنها تهديد لـ”الأمن القومي”.
وفي حين يُردّ هذا السلوك السياسي إلى الاعتبارات السياسية والحقوقية المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ والمترتبة عنها، وهي التي تفترض في المقام الأول انتقال السلطة في الدولة استثنائيا
الجيش الملاذ الأول في إدارة الكوارث والأزمات
في الأزمات الأمنية غير العسكرية، كما في حالات الكوارث الطبيعية، تتعاظم حاجتنا إلى استنفار كافة قوى الدولة وعديدها للتصدي للخطر الداهم حفظًا لأمن المواطن وحماية لأركان الدولة.
من هنا، فإن الأجدى من محاولة إبقاء الجيش بعيداً عن الاستجابة للأزمات المحلية التي تهدد الأمن القومي للدولة، هو إعادة التفكير في دور الجيش في المجتمع والثقة بقدراته على الإدارة الحسنة للأزمات وصناعة القرار.
ويكون من الأجدر بنا في هذا السياق، السعي لتوطيد العلاقات المدنية العسكرية واكتشاف آليات متجددة للتعاون مع الجيش ليتم استخدام أصوله بفعالية في الاستجابة للكوارث والأزمات، بما يتعدى إمداد الأفراد بالمستلزمات.
في المبدأ، وفي مكافحة الظاهرة الداهمة، لا يجوز للدولة اعتماد النهج العسكري إزاء كل قضية تجد فيها خطرًا على أمنها العام؛ حيث تتركّز المهمة الأساسية للجيش على دوره الاستراتيجي الدفاعي عن الوطن بوجه كل تهديد يمس الدولة على صعيد البيئة الدولية.
وعليه، غالبًا ما تقتصر مهام المؤسسة العسكرية على ردع العدوان الخارجي، وانتشار الجيش على الحدود وفي مناطق معينة استراتيجية، إن للقتال أو الاستعداد لخوض الحرب إذا ما اقتضت الظروف.
ولكن يجب الاعتراف بحقيقة أننا نشهد اليوم، أكثر من أي وقت مضى، فعالية دور المؤسسة العسكرية في القضايا غير العسكرية التي تمس أمن المواطن، على الرغم من معارضة عدد من المنظمات الدولية المدنية أي توسع في دور الجيش في البيئات الإنسانية، وتأكيد الأمم المتحدة في المبادئ التوجيهية للعسكريين والمهنيين المعنيين بالمسائل المدنية العسكرية على عدم وجوب استخدام الأصول العسكرية إلا كملاذ أخير.
بيد أنّه من المهم الإضاءة على دور الجيش في الاستجابة للطوارئ المحلية، ولزومه حتى في الأزمات غير العسكرية، مؤكدين على وجوب أن يتحدد هذا الدور بالعلاقة التي تربط المواطنين مع الجيش مع مراعاة الطبيعة السياسية للحكم داخل الدولة.
وعلى الرغم أن القوى الكبرى والمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة لم تتحضر يومًا لهذا الوضع المأساوي إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كانت أول من تحدث عن التحديات القادمة من الطبيعة باعتبارها تحديات تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الدوليين، بما يتطلب تعاون دولي لمواجهتها.
فقد حددت الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2010 نوعين من التحديات الدولية التي يجب العمل بشكل جماعي على مواجهتها وأكدت إدارة الرئيس باراك أوباما متغيرين في إطارهما العام يمثل تهديد للأمن والاستقرار الدوليين، الأول التحدي الإنساني الصادر عن البشر، ويشمل كل ما يتعلق بالإرهاب والأمن العالمي، وانتشار الجريمة المنظمة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والفقر والجوع، وانتهاك حقوق الإنسان، والحريات العامة،
إضافة للمتغيرات التي تتعلق بمنافسة الفواعل الدولية الأخرى لواشنطن على الساحة الدولية. أما التحدي الثاني يتمثل في الكوارث الطبيعية، الكوارث الطبيعية والزلازل، والبراكين، والأعاصير، والفيضانات والاحتباس الحراري، وعلى الرغم أنها تمثل تحديًا اقتصاديًا وبيئيًا للدولة، إلا انها تعد أقل تهديدًا من التحدي الأول، كون التحدي الإنساني له أهداف مضرة مختلفة عن التحديات الطبيعية.
اليوم، تعكف بعض الجيوش الى إعادة النظر في بنيتها العسكرية ومعداتها الحربية، وتجري استعداداتها للتكيف مع المستجدات التي فرضها الوباء، ففي تقرير لشبكة “فوكس نيوز” الإخبارية، بدأت وزارة الدفاع الأميركية بالفعل في استكشاف طريقة للتأقلم مع الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا.
ويشير التقرير إلى إمكانية تزويد الدبابات والعربات المدرعة وكذلك الطائرات المقاتلة، بأجهزة تنفس اصطناعي وأدوية مضادة للفيروسات ومعدات تعقيم متقدمة. وفضلا عن ذلك، سيعزز انتشار الفيروس التركيز على تصميم أسلحة مقاومة للحرب البيولوجية، وتغيير استراتيجيات الحروب التقليدية بما يتناسب مع استخدام الفيروسات كسلاح، بحسب التقرير.
ويتوقع المصدر أن يحمل الجنود مستقبلا معدات متطورة تقيهم من الفيروسات، وربما تحتاج السفن الحربية أيضا إلى إضافة أنواع جديدة من تقنيات الحرب البيولوجية إلى أنظمة دفاعاتها الحالية. ويرجح أن تفكر البحرية بالفعل في أنواع جديدة من صواريخ اعتراضية مجهزة بنظام الدفاع البيولوجي، وربما يتم تصميم طائرات حربية مزودة بتقنيات هوائية لصد أي هجوم “بالأمراض” عبر الجو.
في ضوء ذلك، سيكون من البديهي زيادة عدد الأطباء العسكريين والمستشفيات الحربية المتنقلة، المزودة بالأدوية والتقنيات اللازمة لمكافحة أمراض جديدة قد يطلقها الأعداء كسلاح. ومع وضع كل هذه الاحتمالات المثيرة للقلق في الاعتبار، بدأ كبار قادة الجيش الأميركي بالفعل التفكير في هندسة تقنيات حربية جديدة، ورسم استراتيجيات مستقبلية للدفاع.
في الخلاصة
لقد قرأنا الكثير من التقارير حول نسب هذا الوباء الى عمل عسكري مقصود، وحاولت قوى عالمية تحميل خصومها مسؤولية هكذا أفعال. ولم تتوانَ الصين، مثلاً، عن الإشارة إلى أنّ الفيروس سلاح بيولوجي أميركي أريدَ به ضرب اقتصاد الصين، وهو ما يضع هكذا “هجوم” في إطار الإرهاب الدولي؛
في حين أصرّ الرئيس الأميركي، ترامب بمقابل ذلك، على تسمية كوفيد-19 بـ “الفيروس الصيني” فيما يبدو رداً على التصريحات الصينية، وبالتالي اعتباره تهديد خارجي للأمن القومي الأميركي كما للأمن العالمي.
وسواء كان الوباء المستجد عملاً عسكريًا أو لم يكن، فإن الأزمة الحقيقية اليوم ليست تلك الحالة الأمنية الماسة بسيادة الدولة بل بالإنسان، كل إنسان، من دون أي اعتبار لجنسيته أو لانتمائه ومعتقداته. ومتى ما كان هذا التهديد العالمي يتعلق بالأمن الصحي لكل المواطنين في كل دولة، فإنه دون شك يتصدّر في الأمن القومي للدول
ويستدعي استنفار المؤسسات العسكرية كما المدنية، وتعاونها على مسؤولية حماية الإنسان وأمنه؛ بل وأنّ عالمية هذا الوباء تستدعي تكاتف الجيوش لحفظ الحياة على الأرض.
قد تكون التحديات الصحية والعواقب الاقتصادية لفيروس كورونا مدمرة، في ظل عدم ازاحة الشكوك التي رافقت فشل التوصل الى أسباب نشوئه وما إذا كانت مختبرات علمية ضالعة في انتاجه سواء عن قلة احتراز أو عن قصد، والتي ستبقى ذات إثر طويل الأمد. بالإضافة الى صعوبة التنبؤ بالعواقب الجيوسياسية الناتجة عن الفيروس،
ما يتطلب تعاوناً دولياً صادقاً تحت المظلة الأممية بتقديم كل الدعم الى منظمة الصحة العالمية لا بحجب الدعم عنها كما لمّحت الإدارة الأميركية مؤخراً، من أجل مواجهة التحديات القادمة من الطبيعة التي أصبحت تشكل خطرًا وجوديًا على الأمن الإنساني والصناعي في عالم مضطرب.
سيدخل عام 2020 كتب التاريخ كسنة لم تكشف فقط عن فشل في الصحة العامة؛ ولكنها تشير أيضاً إلى حقبة من الركود الجيوسياسي ولحظة سقوط النعمة للنظام النيوليبرالي في هذا القرن، من دون القدرة على التنبؤ بالنظام العالمي الجديد، والذي وفق رأي معظم الخبراء، يتجه الى تبني تنبؤات صمويل هنتنغتون بتحقيق مبدأ “صدام الحضارات” بديل لعالم “العولمة” . وقد يتغير مجرى حروب المستقبل في اتجاهين –
وفق التوجهات السياسية للدول العظمى – فإما أن يعاد الأخذ بالعامل الإنساني ويتجه عالمنا الى وقف سباق التسلح الذي أثبت عقمه أمام قوة وخطورة فيروس صغير، وإما تتغلب أطماع قوى الشر على إنسانية الكون وتوظف هكذا فيروسات في خدمة انتاجها العسكري المميت.
لا يزال الوقت مبكراً للتنبؤ بالكيفية التي ستُحسم عليها هذه القضايا. ولكن المؤكد أن جائحة وباء كورونا ستفتح أبواب المستقبل لنقاش وحراك على الصعيد السياسي في العالم، ما قد يؤدي إلى تحولات، على مستوى الدول، وبينها. قد تكون هذه الجائحة هي البوابة لتغيراتٍ آتية.