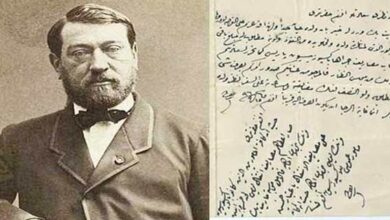مقالات وآراء
علاقة الفقر بالفساد


أثبتت الدراسات بأن الفساد نفسه لا ينتج فقراً بصورة مباشرة وانما يأتي تأثير الفساد على الفقر من خلال تأثير الأول على النمو الاقتصادي والحاكمية المؤسسية للدولة، ومن خلالهما ينتقل تأثير الفساد الى الفقر فيزداد حجمه ويتسع نطاقه. اذا فالعلاقة ما بين الفساد والفقر علاقة غير مباشرة ويمكن تفسيرها من خلال نموذجي النمو الاقتصادي والحاكمية المؤسسية.
نموذج النمو الاقتصادي يشير الى أن الفساد يؤثر على الفقر من خلال تأثيره أولا على عوامل النمو الاقتصادي وبدورها تؤثر الأخيرة على مستويات الفقر. فالنظرية الاقتصادية والتجارب العملية تشير الى أن هنالك علاقة مباشرة ما بين الفساد والنمو الاقتصادي.
فالفساد يعيق النمو الاقتصادي عن طريق احباط الاستثمار المحلي والاجنبي ومن خلال فرض ضرائب غير عادلة على الرياديين وتخفيض نوعية الخدمات العامة والبنية التحتية وتخفيض الايرادات الضريبية وتشويه محتوى النفقات العامة. كما أن الفساد يؤدي الى مضاعفة عدم المساواة في الدخل حيث أن الفساد يؤدي الى تشويه الاقتصاد وأطر السياسات الاقتصادية والتشريعية بحيث تسمح لعدد قليل من السكان الاستفادة من النمو الاقتصادي أكثر من غيرهم، وبذلك تتسع الفجوة ما بين الفقراء والاغنياء فترتفع معدلات الفقر.
فقد بينت الدراسات الأثر السلبي الذي يُحدثه الفساد فيما يتعلق بتوزيع الثروة والدخل من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام، بالإضافة الى قدرتهم على مراكمة الأصول بصفة مستمرة مما يؤدي الى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع.
أما فيما يتعلق بنموذج الحاكمية المؤسسية، فتشير الدراسات الى أن الفساد يؤثر على الفقر من خلال تأثيره على عوامل الحاكمية المؤسسية والتي بدورها تؤثر على مستويات الفقر. فالفساد يخفض قدرات الحاكمية المؤسسية، بمعنى أنه يضعف المؤسسات السياسية ومشاركة المواطنين ويؤدي بالتالي الى التأثير سلباً على الشرائح التي تعاني من جراء تخفيض مستوى ونوعية الخدمات العامة، فعندما تُمنح البرامج الكثيفة رأس المال فرصاً أكبر ويستفيد منها أولئك الباحثون عن مستويات مرتفعة من الدخل الريعي على حساب النفقات التعليمية والصحية، فان ذوي الدخول المنخفضة سيخسرون بعض الخدمات العامة التي يعتمدون عليها في ادائهم لأعمالهم.

فالفساد يكون عادة مرتبطاً بارتفاع معدلات الانسحاب من المدارس وارتفاع معدلات وفيات الاطفال الرضع. كما أن تراجع الخدمات العامة وانعدام الثقة بها يؤدي الى فقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية، والتي تعتبر عنصرا هاما من ما يسمى برأس المال الاجتماعي. فكلما تراجعت الثقة بالمؤسسات العامة والبنية التحتية فان هشاشة الفقراء تزداد لأن انتاجيتهم ستتأثر. وعندما يشعر المواطنون بأن النظام الاجتماعي لا ثقة فيه وغير عادل فان حافزهم للمشاركة في النشاط الاقتصادي يتراجع.
لذلك على برامج مكافحة الفساد أن تدرك أن تعاملها مع سياسات النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل والحاكمية المؤسسية والخدمات الحكومية في الصحة والتعليم والثقة في المؤسسات الحكومية من شأنه تخفيض ليس فقط الفساد وانما الفقر أيضاً.
تعتبر ظاهرة الفساد الإداري ظاهره عالميه واسعة الانتشار وذات جذور عريقة وقديمة مدى التاريخ ومن ذلك العمق التاريخي وحتى يومنا هذا استمرت الدراسات لتقديم النصيحة لاجتناب أسلوب الفساد الإداري وهذه الظاهرة حظيت بالاهتمام من قبل الباحثين في مختلف التخصصات الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية ولدراسة هذه الظاهرة رأينا التعرض لمفهوم الفساد بصوره عامه ومن بعد ذلك الدخول في مفهوم الفساد الإداري وأسبابه ثم علاجه
أما بخصوص الفقر لكونه ظاهرة تتصدر المشهد الاجتماعي في الدول العربية فمؤشراته خطيرة مقلقة وبالتالي فالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها هذه الدول لم تساهم فقط في تعميق هذه الظاهرة بل أصبحت البيئة الحاضنة للسياسات الاقتصادية الخارجية التي ساعدت في تنامي الفقر أي ارتفع معدل هذه الظاهرة إلى ما يزيد عن ثلث السكان (34 – 36 في المائة)
ان التباين في النظر إلى أهمية الفقر يعود إلى التباين في توزيع الدخل ولا سيما ذلك الجزء الذي يسمى “بالفائض” والذي يتحقق من النشاط الاقتصادي في الدول العربية متوسطة الدخل ومن “الريع” في البلدان النفطية ويقود الفقر الى تفشي ثقافته التي تؤدي في النهاية إلى إحساس غالبية المهمشين ولاسيما الشباب منهم بالغربة عن وطنهم وتطلعاتهم الى الهجرة،
كما يؤدي عدم المساواة الى صراعات تقيد حركة المجتمع في سعيه الى الحداثة والتقدم بسبب استبعاد كتلة بشرية ضخمة هي مجموعة الفقراء.. ولا تقتصر – كما يقول المؤلف أسباب انتشار الفقر على ندرة الموارد الطبيعية وعلى السياسات الاقتصادية، بل تشمل أيضا اتجاهات الاقتصاد العالمي والمتغيّرات الخارجية المؤثرة في ظاهرة الفقر او في الحد منها ولاسيما ان الحكومات العربية سارعت الى توسيع حالة الانفتاح الاقتصادي والتجاوب مع أجواء العولمة خلال العقدين الماضيين.
وأدى تطبيق تلك السياسات الى نشوء أوضاع اقتصادية جديدة ساعدت على انتشار الفقر الذي تتطلب مكافحته وضع برامج إنمائية خاصة تنسجم مع البيئة الاقتصادية والثقافية والتمسك بدولة الرعاية الاجتماعية وتحسين مناخ الا إن نفس الإنسان فيها جوانب الخير والشر وان النفس أماره بالسوء ولذلك نجد الإنسان في صراع دائم مع النفس فلابد من إدارة الصراع الداخلي الذي يشعر به الفرد عن طريق ما يلي :-

تزويد الفرد بالقيم والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية السليمة والعمل على تحديد للرواتب يوافق مستوى المعيشة السائد في المجتمع وظروف الغلاء حتى يشعر الفرد بالرضى مما يتقاضاه ، ولا يشعر بالصراع بين قوى الشر المتمثلة في الرشاوى و التزوير وغيرها وبين قوى الخير النابعة من فطرته القومية التي فطر الله الناس عليها.
لقد تزايد الاهتمام بظاهرة الفساد خلال العقود الأخيرة بشكل غير مسبوق، وتواترت تبعا لذلك العديد من الدراسات التي تتفق على خطورتها وآثارها خاصة على الفئات التي تعاني من هشاشة اجتماعية أن الدول الفقيرة هي التي تتحمل أكبر الأضرار في هذا الجانب، بسبب افتقارها إلى مقومات مكافحته بالرغم من توقيع بعضها وتصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
أن الفساد أكثر انتشارا في دول العالم الثالث لأن الوصول إلى الحكم يتم فيها بطرق غير مشروعة مما يؤدي إلى “قيام السياسيين باستغلال مراكزهم من أجل المنفعة الخاصة” أي إلى الفساد إذا اعتبرنا التعريف الذي أعطته عدد من المؤسسات الدولية المعنية لهذه الظاهرة.
هذا الطرح يجعل مكافحة الفساد تدور في حلقة مفرغة، شبيهة بالحلقة المفرغة كما عبر عنها عدد من الاقتصاديين في تحليل أسباب التخلف. ذلك أن ممارسة السياسيين للفساد، يؤدي إلى “إجراء تغييرات في بنية الدولة وفي قلب المعادلات السياسية” وبالتالي استغلال ضعف السلطة وآليات المراقبة لتحقيق المصالح الخاصة من خلال تجاوز القوانين ونهب المال العام الذي هم مؤتمنون عليه، وهكذا في شكل دائرة يصعب نسفها.
الفساد بهذا الشكل يحرم الكثير من أفراد المجتمع من إمكانيات الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية وكذلك من جزء كبير من نصيبهم في الثروة الوطنية، ويكرس واقع الفقر ويزيد من معاناة الفقراء “فالفساد يمثل الشر الأساسي (الذي) يدع الملايين من البشر أسرى البؤس والفقر والمرض والصراعات وأشكال الاستغلال الوحشية”
بالإضافة إلى ضعف السلطة السياسية هناك عدة أسباب متعارف عليها في كل الأدبيات التي تناولت هذه الظاهرة، من عدم تطبيق القوانين، والثغرات التي يمكن أن تتخلل مساطر خصصه ممتلكات الدولة أو إبرام العقود الحكومية المتعلقة بصفقات مشاريع المنشآت والبنيات الأساسية، وعدم وضوح آليات التوظيف في المناصب العمومية،
فبعد أن يعمل على تقديم بعض التعريفات المتداولة للفساد ونتائجه، وتناول بعض مظاهر الفساد السياسي وتأثير المال في الحياة السياسية حيث يتدخل من خلال التمويل في رسم المشهد السياسي والانتخابي مع ما يترتب عنه من تهديد للممارسات الديمقراطية ولمؤسسات الدولة وهيبتها وبالتبعية فقدان الناس للثقة فيها، ينتقل بشكل مفاجئ لمناقشة الفقر في العالم العربي،
انطلاقا من تقارير بعض المنظمات الدولية التي لا تتضمن “إحصاءات تشير إلى التقدم، بل إلى ظواهر توصف بالاستبداد وعدم الشفافية” التي يرى فيها “مؤشرات دالة في قياس الفقر وعلى غرار الفساد، يضيف التنير إلى أسباب انتشار الفقر في الدول العربية ( ندرة الموارد الطبيعية والسياسات الاقتصادية المفروضة من البنك وصندوق النقد الدوليين التي لا تراعي الأبعاد الاجتماعية لأفراد المجتمع، وارتفاع عدد السكان، وغير ذلك)، أسبابا أخرى ترتبط في الأساس بانفتاح اقتصاد الدول العربية على الاقتصاد العالمي “والتجاوب مع أجواء العولمة … خلال العقدين الماضيين”
تبدو العولمة بمثابة الشر المطلق بسبب آثارها الجانبية على الدول التي ركبت قطارها، لأنها قضت على الدولة الراعية أو قلصت من أدوارها في “الدعم” الاجتماعي لأفرادها الفقراء على الخصوص. في هذا السياق يجزم الكاتب بأن رياح “العولمة سيئة الذكر” هي السبب الأهم في اتساع دائرة الفقر الذي “باتت إزالته أمرا صعبا جدا”.
هذا الحكم الجازم، وبالرغم من الطابع الشمولي للعولمة، دفع بالمؤلف إلى الإقرار بأن تقليص الفقر يكمن في “الانتقائية في تطبيق مبادئ العولمة”. بيد أن هذا الأمر يبدو صعبا في الواقع، وذلك انطلاقا من تحليل اتجاهات الاقتصاد العالمي خاصة مع تراجع النموذج الاشتراكي منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين. فالدول الصناعية المنخرطة بشكل كامل في مسلسل العولمة تحظى بنحو ثلثي الاستثمارات الأجنبية عبر العالم، وغير خاف أن هذه التدفقات تساهم في تقليص معدلات البطالة التي هي نتيجة لفقر الدولة وسبب من أسباب فقر سكانها.
ومهما يكن الموقف من العولمة التي لها بالتأكيد شرورها، لأنها قائمة على فكرة “الخمس الغني في مقابل الأربعة أخماس الفقيرة” كما جاء في كتاب “فخ العولمة” لمؤلفيه هانس بيتر مارتن وهارالد شومان، فإنه من المستبعد استفادة الدول العربية من محاسنها بدون الانفتاح على الاقتصاد العالمي. لا يتعلق الأمر هنا فقط بجذب الاستثمارات الأجنبية، بل أيضا بصعوبة التكامل الاقتصادي العربي نتيجة التبعية للغرب على الخصوص، المتولدة عن التقسيم الدولي للعمل الذي وضعته الدول المتقدمة (اقتصاديا وعسكريا وإعلاميا) فغدا من شبه المستحيل، خاصة في ظل الخلافات العربية والأوضاع الراهنة غير المستقرة، إطلاق العنان حتى للتفكير في إمكانية الحد من هذه التبعية.
أن هذا لن يتحقق إلا عن طريق رفع الاستثمارات، ومعلوم أن ذلك لن يتم فقط من خلال الاستثمارات الوطنية، بل الأجنبية أيضا. أضف إلى ذلك أن الغرب، على وجه خاص، هو الذي يملك المعرفة العلمية “التي يحتكرها عدد قليل من الدول أهمها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وروسيا”
وبالتالي تبدو قضية منع هجرة الأدمغة مرتبطة على وجه مؤكد بخلق فرص لجذب رؤوس الأموال الأجنبية المالكة لتلك المعرفة، وهذا لن يتحقق دون الانخراط في “التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد العالمي” التي تسعى بشكل متزايد لخلق عالم معولم أكثر فأكثر، تتجاذبه المنافسة بين الدول على أكثر من صعيد، ويؤثر فيه الاقتصاد الأمريكي على نحو كبير باعتراف المؤلف نفسه، حتى “بات أي اقتصاد غير قادر على التطور بمعزل عن ظاهرة العولمة التي غيرت البيئات الاقتصادية كافة في العالم
فإذا كانت في نظره سببا مباشرا في ارتفاع معدلات الفقر ومؤشرات الفساد، فسرعان ما تغيب هذه القناعة من خلال اعتباره لها في أكثر من موضع الجزء الأساسي من الحل. بل إنه يراجع حكمه المطلق بشأنها داعيا إلى “دراسة العولمة بشكل شامل واستعمال ، للكشف عما لها وما عليها.