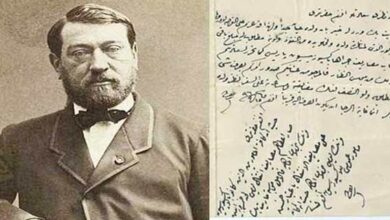الصراع بين القانون والضمير


الدكتور عادل عامر
الضمير جنة الإنسان وسجنه. فخطأ العقل في اختيارٍ ما مثلاً قد يجر العقل إلى إصلاح الخطأ وتجاوزه نحو فعل آخر وقرار آخر. ولكن أن يصلح العقل خطأ قرار ما ويغيِّره بموقف جديد جميل وموفَّق لا يعني أن المسألة قد انتهت،
وإنما يعني أن المسألة قد بدأت وقتها، لأن قوة الضمير ستحمّل نفسها مسؤولية القرار الخطأ حتى وإن أصلحناه وغيرناه، وهي مسؤولية واقعية وفعلية ستبقى آثارها في النفس وفي الآخرين، لأن البشر سيلتقطون هذه الأفعال ويمارسونها رغم تراجع العقل عن قراره وإصلاحه لخطئه.
على الأمر الأخلاقي النابع من النفس أن يكون مطلقاً لا شرطياً حتى يكون كلياً، ومن ثم يأخذ طابع الضرورة المطلقة، بحيث لا تستطيع النفس مخالفته، وإلا تسبَّب ذلك في مخالفة الضمير؛ لأن العقل العملي عندما يصدر أوامره الأخلاقية فإن أوامره لا تكون إلا قاطعة كلية وغير مشروطة.
ويعبِّر كانط عن هذا الأمر بقوله: “افعل فقط طبقاً للمبدأ الذاتي الذي يجعلك تقدر على أن تريد له في الوقت نفسه أن يصير قانوناً كلياً”. ووفق هذا القانون، فإن الضمير لا يختلف من شخص لآخر أو من مجتمع لآخر أو من زمان لآخر، فهو عند الإنسان فرداً وجماعة في كل مكان وزمان. ولا يمكن القول إن ضمائر الناس متغيرة أو مختلفة لأن أصلها واحد وهو العقل العملي الموجود في كل إنسان عاقل حر.
إذا سلَّمنا بهذا الاستنتاج الذي يقرّه الواقـع الفعلي للحياة الإنسانية فإن السؤال الذي لا يمكـن ردّه في هذا المقام، هو: كيف يستقـر صوت المجتمع فينا، ويصنع هذه القوة العميقــة في باطننا التي نسميها الضمير؟
ولأن القانون والعدالة مفهومان مختلفان، الاول واقعى والثاني قيمي، فليس غريبا أن يكون هناك قانون ظالم أو حكم قضائي غير عادل. والفجوة بينهما هي ما يجعل الجدل القانوني والدستوري مطلوبا في كل مجتمع ومصدرا للتقدم والترقي لأنه الوسيلة الوحيدة للتحقق من أن القانون ليس بعيدا عن العدالة، بل قريبا منها وساعيا لها ولو لم يبلغها. والقول الشائع بأن الحكم عنوان الحقيقة لا يعنى أن الحكم القضائي بالضرورة عادل وإنما أنه لأسباب عملية وواقعية يجب أن يتمتع بمرجعية مطلقة في تحديد الحقوق والواجبات والاوضاع القانونية دون أن يعنى ذلك أنه يعبر عن العدالة.
ولهذا فإن الحكم القضائي يكون جديرا بالإلغاء أو المراجعة من محكمة الدرجة الاعلى ليس حينما يكون غير عادل بل عندما يخالف تطبيق أو تفسير القانون. وبسبب هذا التناقض المستمر فإن القاضي ذا الضمير اليقظ، حينما يجد نفسه أمام حالة صارخة يتعارض فيها القانون مع العدالة، يبحث عن مخرج إجرائي أو تفسير مبتكر أو نص قانونى مهمل أو حكم سابق يرجح به العدالة على التطبيق التقليدي للقانون ولكن دون أن يسمح لنفسه بمخالفته بشكل صريح.
العنف ناتج عن غيبة الضمير الإنساني. إنه الاستخدام غير الأخلاقي للقوة المادية المعنوية. قد يكون العنف غير الأخلاقي فرديا أو مؤسسيا صادرا من جماعات وتنظيمات أو من مؤسسة الدولة ذاتها.
استناد العنف الذى تمارسه الدولة إلى قواعد قانونية، لا يضفى عليه مشروعية أخلاقية، خاصة في المجتمعات التي تدار بإرادة فرد، والتي يعبر فيها القانون عن إرادة الاستبداد. هنا يكون العنف الرسمي حافزا على العنف الفردي المضاد. الحالة الوحيدة الذى يكتسب فيها عنف الدولة مشروعية أخلاقية أن يكون مستندا إلى قانون ديمقراطي عادل يحظى باقتناع عام بعدالته ويهدف إلى حماية أمن المجتمع من الأخطار ومن عنف الإرهاب اللا أخلاقي. دولة بلا ضمير إنساني وتبرير أخلاقي لسلوكها هي أقرب للعصبة المسيطرة منها للدولة.
في كل الدول توجد ثلاث قوى للجبر القانوني المشروع (الأمن الداخلي والأمن الخارجي والقضاء)، بدونها تكون الدولة بلا أذرع تحميها. وهذه القوى تحتكر العنف بشرط أن يكون عادلا ومبررا أخلاقيا لحماية مجتمعها. فإذا تحرر عنف الدولة من المعايير القانونية أو الخلقية كان معولا لهدم الدولة ذاتها.
وتطبيقا لذلك، لا يقبل أن تقتص سلطات الجبر لنفسها متحصنة وراء حماية يتيحها لها القانون لممارسة وظائفها. هنا ننتقل من مجتمع الدولة العادلة الأخلاقية إلى مجتمع الطوائف التي تستخدم سلطاتها للدفاع عن مصالحها وسطوتها. مثلما كما كان الحال في فرق الجند والمماليك في مصر العثمانية كالانكشارية وغيرها حيث كان الولاء للطائفة مقدما على ما عداه.
دائما ما تطالعنا وسائل الإعلام في وطننا العربي بأخبار غريبة وصادمة وغير منطقية، فقتل أحدهم لابن عمه لأنه عسكري يعمل لخدمة وطنه خبر مفجع، يندى له الجميع، وطعن آخر لأمه خبر يقطع القلوب السليمة، أما استخراج قلوب الأسرى وذبحهم ذبح الشاة أو حرقهم فهو أفظع مما تحتمله النفس السليمة. ويقابل الجمهور هذه الأخبار بكم كبير من الاستغراب والإدانة والتشنيع، ودائماً ما نطرح سؤالاً على أنفسنا، نستفهم عن مصدر هذه الوحشية وكيف ظهرت فجأة. مشكلتنا كعرب ومسلمين أننا نرمي مسؤولية حماية المجتمع والأمة على الوعظ والضمير، فالسرقة والقتل والمخدرات والجرائم الأخرى، يجب أن تكافح عبر المنابر والخطب الوعظية، أو عبر تبريرات عقلية – منطقية قبح الجريمة
تفضي إلى قبح الجريمة وحسن العدل. الغرب من جهة أخرى، يحترم العقل والضمير، لكنه لا يرمي مسؤولية حفظ النظام على العقل أو الضمير، لأن عقول الناس تختلف، ومنطقها يختلف، وتبريراتها تختلف، وضمائرها تتفاوت. الغرب يضع مسؤولية حفظ النظام بين الناس وبين الدولة وبين المختلف على عاتق القانون، لأن القانون هو كتلة صماء ذات معان محددة – ليس بالمطلق، ولكن بالأغلب – واضحة التفسيرات والنتائج، لتكون هي قاعدة حفظ النظام بين المختلفين – دينيا وعرقيا وسياسيا لأن وضع حفظ النظام على عاتق الضمير والعقل يفضي إلى استغلال الغلبة العددية، أو تغليب الايدلوجيا على المختلف، أو الانتقام من المختلف عبر قوانين لا يؤمن بها، أو عقائد تختلف مع عقيدته الإيمانية. ومن الأخطاء القاتلة الاعتماد على مبدأ أن البشر بطبيعتهم طيبون متآخون، لا يعكر صفو عيشهم شيء، ولو تُرك البشر على سجيتهم وفطرتهم لأصبحوا في أفضل حال. ومن يميل إلى هذا التفسير دائما ما يحاول تحصين الناس بالتحذير من الحسد والتعدي على الآخرين، عبر الخطب الوعظية التي تدعو إلى العمل الصالح. إن أصحاب هذا الرأي يستندون دائما إلى استخدام هذا الأسلوب حتى في القضايا التي تحتاج إلى حلول أكبر
وأكثر تعقيدا من مجرد الوعظ، فالبعض منهم قد يتجه إلى معالجة الفساد الإداري أو الأخلاقي بهذا الأسلوب نفسه، الذي يفترض ملائكية البشر. مشكلة العرب عموماً هي أن تقييمهم لتاريخهم والأحداث التي تدور حولهم دائماً ما يأتي بشكل عاطفي، ودائماً ما نرمي أسباب مشكلاتنا على الغرب القبيح، الذي يريد هدم الإسلام واستهداف المسلمين
وتشويه صورتهم، ومن ثم السيطرة على ثرواتهم ومقدراتهم. وإذا كان الإنسان كائنا ناطقا، فالعربي كائن عاطفي، يتعامل حتى مع الظواهر الطبيعية بشكل عاطفي، ففيضانات الصين هي غضب إلهي، وفيضانات إندونيسيا اختبار من الله لعباده المسلمين، وكأن الصينيين ليسوا من عباد الله.
وأصبح مصطلحُ القيم واحداً من المفردات التي يستعملها كلُّ الناس، في كلِّ المجالات؛ فالصراعُ بين القوى المهيمنة في العالَم يتمُّ تسويغُه بالسَعْي لنشْر قيم الحريَّة والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ والجشعُ في التنافس الاقتصادي بين الشركات الكبرى في العالم يتمُّ تبريرُه بالسعي لإشاعة قيم السوق، المتمثلة في تحرير التجارة وتحقيق معايير الجودة؛ والتطرُّفُ الديني والطائفي والعرقي يتم تسويقُه بالحرص على قيم الهوية، في مواجهة تيارات الاستلاب والتحرُّر التي تُرَوِّج لقيم العولمة، إلخ.
لذلك لا عجبَ أنْ أصبحَ موضوعُ القيم مادةً للبحث والدراسة، يستقطب اهتمامَ الباحثين من مختلف المذاهب والإيديولوجيات، ومن مختلف الحقول والتخصصات المعرفية؛ فهو موضوعٌ أثيرٌ في البحوث الفلسفية، والدراسات السياسية، وهو موضوعٌ مركزيٌ في علوم الدين وعلوم الاقتصاد والاجتماع، والدراسات الثقافية، والحضارية، إلخ، هذا فضلاً عن أنَّ موضوعَ القيمِ يتعلق بالفطرة الإنسانية، ويضربُ بعيداً في عمق التاريخ البشري، سواءً اعتمدنا على النص الديني في معرفة هذا التاريخ، أو اعتمدنا نصوص التاريخ البشري المدوَّن.
ومع كلِّ هذا الاهتمام فإنَّ البحث الجادَّ سوفَ يقودُ إلى ملاحظة أنَّ القيمَ قد تعرَّضت في مناسبات عديدة إلى قدر كبير من التهميش، مما يؤكِّدُ الحاجةَ إلى الكشف عن العوامل التي أدَّت إلى ذلك، وبيانِ دورِ المعتقدات والإيديولوجيات، إضافةً إلى بيان موقعِ القيم من دعاوى الإطلاق والنسبية، وخصائصِ التغيُّر والثبات.
وبعد أن كانت الشعوب تتمتع بخصوصيات ثقافية أو دينية تعدُّها خصوصيات مُقدَّسة، أخذت هذه الخصوصيات تُخلي مواقعَها أمام “الشرعية الدولية” بوصفها “مرجعية” لا سبيل إلى تجاوزها. وبعد أن كانت الشرعية الدولية قرارات سياسيةً وعسكرية، أصبحت قرارات تتعلق بحقوق الإنسان، والثقافة السكانية، والمجتمع المدني، وحقوق المرأة، ومفهوم الأسرة، إلخ. وبذلك أصبح مفهوم القيم العالمية واحداً من موضوعات الحرب الفكرية التي ترافق أشكال الحرب الأخرى،
بهدف كسب العقول والقلوب، وتدور رحاها في ميادين التعليم والإعلام والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتحاول فيها القوى الكبرى في العالم أن تنشر مبادئها وقيمَها، وتفرضَها على الكيانات الضعيفة.