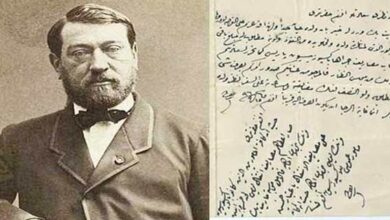مقالات وآراء
التي أعدَّت موتها..


د. أماني فؤاد
(1)
أحكمتُ حزام المقعد، والتقطتُ أنفاسي الغاضبةَ، لماذا أنا؟!
قبضتُ بيدَيَّ على الذراعَين؛ لألتصِق بأيِّ شيء، رميت رأسي المنهَكَ الرافض إلى الخلْف، لم أزَلْ لا أصدِّق، أجراس تدُقُّ في أُذُنَيَّ، وإعصار أسود يعصف بي، مَن لِبَناتي الثلاث؟ تمنَّيت ألَّا يجلس بجواري أحدٌ في العودة، أشعر أن دموعي – التي انحبست في صدري طيلة الثلاثة أشهر الأخيرة – ستنهمر، هو الموت إذن.
”لم تَعُد هناك جدوى من مواصلة العلاج”. هكذا سقطت الكلمات الأخيرة للطبيب الألماني (جوستاف)، رفَع رايته البيضاءَ بعد أكثر من عام، قال: انتصر علينا الإرهابيُّ الصغيرُ الذي شَيْطَنَ خلاياك. كان قد حاصره مِرَارًا، يحقنه في المناطق التي يحتلُّها من جسدي، يصفه بأنه شديد الجنون. يفتقرون هنا لتجميل الصَّدَمات.
أنا المرأة التي ماتت مِرَارًا؛ بحثًا عن حياة حقيقة، أكثر ما كرهت الزيف. حين فتحت جفوني التي باتت دون رموش؛ كانت الطائرة تُقلع، أشياء أخرى تغادرني، تنسحب من كياني، لبرهة شعرت أنني لا أعرف من أنا، أعود إلى أين؟ منطقة بيضاء تسحبني، دون أن أدري أتهاوَى.
أفيق، وأتراجع، أشياء كثيرة لم تَزَل عالقة، انتبهت على وميض يتسارع ويعلو في جروح معصم يدي اليسرى القطعية، أعرفها هذه الآلام، تعايشت معها، منذ قطعتُ يدي منذ سبعة وعشرين عامًا؛ يأسا وضيقا، وليعرف الجميع أنني جادة في خلعه، كيف لدمائي التي احترقت بالكيماوي أن تظَلَّ تتوهَّج بضوء أو شعور، منذ شهور أراقب البقع السوداءَ، العتمة التي تتَّسع أمام عينَيَّ.
(2)
مثل شريط سينمائي تتوالى كلمات (سارة):
ــأين أبي؟
ــ لا أعرف. قلت وأنا لا أنظر إلى شيء.
ــ أسأل مَن عنه؟
ــ لا أعرف. أعدتُ قولي مرَّة أخرى: لا أعرف. ثم أعقبته سريعا: آخِر ما وصلني عنه أنه افتتح “نايت كلَب” في الغردقة.
ــ نظرتْ إليَّ طويلا ثم قالت: “ألم تقولي ضَعِي في خانة عمله أنه مهندس معماري؟”
ــ نعم. كان مهندِسًا، لكنه غيَّر عمَله.
ــ لماذا لا تعيشان معًا؟.
ــ انفصلنا وأنت صغيرة، لم تتجاوزي السنتَين.
ــ لماذا؟
ــ لم يكن رجُلًا مسئولًا، حين وُلِدت أختُك (ريم)؛ احترتُ، لا تنتبه لشيء؛ ذاهلة دومًا، حين وَصَلت للرابعة من عمرها؛ صدَمنا الأطباءُ بإصابتها بالتوحُّد. قال: سأُلقي بها في مستشفى العباسية، لن أنفق مليمًا واحدًا. وعندما أردتُ إلحاقَك أنتِ وأختك بمدرستكما الخاصة المميَّزة رفَض، قال: تعاملي أنت ووالدك. لو لم يكن يملك؛ ما غضبتُ، لكنه ميسور الحال، كان بخيلا في كل شيء، عواطفه وعطاءاته.
(3)
تخفَّيت كثيرًا وراء ضحكاتي، التي نثرتها فوق الأيام والسنوات، وانزويت كثيرا، جمعت القوة التي وجدتُها داخلي، ووضعتُها في الصدارة؛ في قمة جبهتي، خلَّقتها بداخلي لِبَنَاتي؛ لئلا يبحثن عن سَنَد، كيف سأتركهن في هذا العراء، ألا يمكن أن تبقيني قليلا أيها الموت؟
أنا فقط من يستطيع قراءة ومضات معصمي التي تنفذ من الروح، أنا الهشة القوية، المرأة التي حاربَت للتخلُّص من زوج بلا نخوة أو كرامة، من التعاسة، من صرامة أمي التي رفضَت طلاقي، من عجزي أمام مرض ابنتي، أنا الهشة التي احتمت بالأشياء، وبحثت فيها عن السعادة، أنا التي قابلت الحُبَّ ثانية، وتزوَّجت سِرًّا من رجُل حقيقيٍّ، فقط أبي من كان يعلم، عِشْتُ معه سعادة النُّقصان، فلست من المخلوقات التي يستهويها الظِّل أو الخفاء، في الأيام التي كنت أنسحب فيها من الحياة، وألوذ بنفْسي، وحدها (سماء)؛ ابنتي الصغرى، كانت تأتيني لتكتب على ذراعي، فوق النتوءات: لا تذهبي، فأنا أحبك.
اعتدت كلَّما وَمَضَ معصمي؛ أن أناشد غضبي الهدوء، كنت أطبِّب نفْسي مع الحياة.
أنا الأم التي أعدَّت منذ شهور لموتها، نعم، أنا الطبيبة التي عرَفت أن أجهزتها ستوالي فشلها واحدًا تِلو الآخَر، بات ما أجَّلته دومًا حتميَّ الحدوث، لابد من استئصال رَحِمِها، (ريم) الشابة الجميلة، وجَعي ذو البشرة الحريرية، سأرحل، أنا ظِلُّها الذي لا يغيب، مَن لها بعد أن أغادر؟
لن تكفي المتخصِّصة لحمايتها، سيظَلُّ جمالُها النقمةَ التي تجلب المتاعب، وهي لا حول ولا قوة، ريم التي لا أعرف لماذا تعاقب رأسها كل حين، فتوالي ضربه في الحائط بهستيرية.
أنا التي تغادر الحياة، أعددت حجْز الرحلة، قبْل أن أصل مصر؛ دعوت أبي والعائلة وابنتي، هناك سأصارحه بما قال الأطباء، سأطلب أن يكتب وصيته؛ لأضمن لِبَناتي قادمَ سنواتهن، أنا التي سأذهب لزوجة (أكمل)، وأطلب منها أن تسامحه، لم نكن نقصد أن يحب أحدُنا الآخَر، أو أن تزهر الدنيا ونحن معًا. أنا التي سأوزِّع على بناتي أشيائي التي احتميت بها، سأترك (ريم) تحت وصاية (سماء)، وأُطلِعها على ما هيَّئْتُه لتأمين حياتهن.
لُطفًا، أنا أيضًا التي ستخلع كل الأنابيب من يدَيْها؛ لتترك لمعصمها أن يومض بحُرية ولو لمرة واحدة، أن تعلو نتوئات جروحه التي لم تلتئم أبدًا؛ أن يتنفَّس.