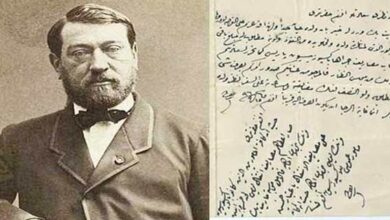مقالات وآراء
كائن كامل الأهلية..


تكتب د. أماني فؤاد
لماذا تُسَنُّ الدساتير، ومواد القوانين المختلفة؟
أحسب أن الإجابة هي: لتحقيق العدل، وضبْط المجتمعات وتعاملاتها شَتَّى، والوصول بالإنسان “المرأة والرجُل” للسواء والسلام مع ذواتهم والآخَرين.
هل المرأة إنسان له الحقوق كافة والواجبات، خُلقت لمشاركة الرجُل الوجود، والسعي معًا، كلٌّ وفْق طبيعته وقدراته، وفي حالة من التكامل، أم أنها كائن خُلق لأجل طاعته وخدمته ومتعته؟
هل لو أن المرأة اشتركت بنِسَب عادلة في وضْع القوانين، التي تنظم الحياة الأسرية، وفي أنواع القضاء كافة، واشتركت أيضًا في تفسيرات النصوص الدينية منذ قرون، وبافتراض جدلي، لو أنها كانت في التاريخ “نبية”، ورُوِيَ عنها بعض الأحاديث، كان من الممكن أن ترضى بما يُطلِق عليه البعض أن تلك القوانين – التي لا تراعي حقوق المرأة – تجليات لشرْع الله؟ هل يمكن أن يمَس شرْع الله ظلمًا؟ أنا على ثقة باستحالة أن يكتنف النور ظلامًا، الله هو العدل.
ما هو مبرر أن تتخلَّى المرأة المطلَّقة عن حضانة أطفالها لو تزوجت مَرَّة أُخرى، كما لا يعود لها ولاية على أولادها؟ ما هو مبرر تعنُّت الأب الذي طلَّق امرأته، وضرورة أخْذ إِذْنه في حالة سَفر الابن، الذي في حضانة أمه للعلاج بالخارج معها؟
ربما يوجد عند البعض مبررات للسؤالين السابقين؛ فقد يقول قائل: إنها لو تزوجت ثانية؛ ستنشغل، ولن تعود مهتمة بأولادها من الرجُل السابق، وإنها هي التي قد تريد التخفُّف من أعبائها وأعباء أولادها، ورأيٌ آخَر قد يقول: في حالة ضرورة أخْذ إِذْن الأب؛ إنها ربما تهرب بالابن أو الابنة بعيدًا عن الأب، وتلك حالات قد تحدث، ولا أريد أن أدَّعِيَ أن المرأة ملاكًا لا يخطئ أو يتعنَّت هو الآخَر.
لكن ملاحظتي تنصَبُّ على شيء آخَر؛ أن التوجُّه العام في الثقافة الذكورية يريد أن يسلب المرأة كيانها الإنساني، الذي يستطيع بذاته، يستطيع أن يقرِّر وأن تَصدُر قراراتُه عقلانيةً، وأن يتَّسِم بالسَّواء والعدل، يرسِّخون للوصاية الدائمة عليها تحت ادِّعاء أنها كائن تتحكم به عواطفه وجسدانيته، وأنها تُعلي شأن الشِّقَّين، وتجعلهما فوق اعتبارات التعقُّل والاتزان، وهو ادِّعاء منافٍ للحقائق بصورة فجَّة، فَكَمْ من النساء التي بلا حصر اقتصرت كل حياتهن على تربية الأولاد فقط، بعد أن طُلِّقن، وتَرَكْنَ كل احتياجاتهن لكي يبقى أولادهن معهن.
هل يمكن أن نقول إنها رغبة المفسرين الرجال، الذين فسَّروا الشَّرع بنوازعهم الذكورية في الهيمنة على المرأة، وحرصهم على امتداد تملُّكهم لها، حتى لو تركوها، ولم تعد زوجة لهم، نوعًا من التسيد واستمرار الملكية المضمَرة، التي تأخذ شكل الاحتكار لهذه المرأة، التي ارتبط بها يومًا، الملكية تحت غطاء أطفاله التي معها، يتناسى هؤلاء المنغمسون في نوازع ذكورية مجتمعية ودينية، أن عاطفة الأمومة لدى معظم النساء هي الأعلى، ولها الأولوية، وأن من حقها كإنسانة – إذا انفصلت – أن تستكمِل حياتها، وتختار من يُسعدها، وأن لحياتها كالرجُل جوانبَ متعدِّدةً، وتستطيع أن تواءم بينها، من حق الجميع وقْتها – الرجُل والمرأة والأولاد بينهما – أن يتم التوافق بينهم على شكل الحياة الأكثر ملائمة للجميع.
لماذا نستمر نرسِّخ أنه على المرأة أن تكون كبش الفداء، وأن تحتمل بمفردها نتائج فشل العلاقة الزوجية، فمن حقها الإنساني أن تبدأ حياة أخرى، لو أن حياتها السابقة فشلت، ومن حقها أن يظل معها حضانة أطفالها الصغار، لو أنها ارتبطت مَرَّة أخرى، منطق الأمور وطبيعة المرأة يقول: إنها لن تهمل أطفالها، ولن تجعلهم الدرجة الثانية من اهتماماتها، هذا هو الأصل، العكس هو الأمر الشاذ، وللأب وقتها وللقضاء إذا حدث الاستثناء؛ أن يُسقِط حضانتها، لو أنها أهملت أولادها.
هل يفكر المجتمع، والرجال مفسِّري الشرع، وواضعي القوانين، في المرأة على أنها كائن كامل الأهلية، متَّزن وعقلاني؟ هل يفكرون فيها أنها كائن يستطيع بذاته دون الاعتماد على آخَر يأخذ لها القرار، هل فكر الجميع أن المرأة، التي كانت في العصور الأولى ــ حين إقرار بنود هذا الشرع ــ تغيَّرت بصورة جذرية مع التطورات التي لحقت بها مع الزمن، والتطورات التي لحقت بشخصيتها؟
لماذا نترك قضايا النساء تأكل أعمارهن، ونفسياتهن، وتصيبهن بالأذى المادي والمعنوي سنوات وسنوات، لماذا لا نتوجَّه لتلك القوانين التي تسحق المرأة في المحاكم والقضايا، وتتركها تُستنزَف ماديًّا ومعنويًّا مع دوَّامة المحاميين، ومراحل التقاضي المختلفة، وعدد من القضايا المتعددة التي تعالج كل فرعية على حدة. لنُسائل تلك القوانين عن عقلانيتها ومنطقيتها وإنسانيتها، وهل تراعي حقوق المرأة ككائن إنساني مكتمِل القدرات والاحتياجات، لماذا لا نطالب بالقضاء الناجز، الذي لا يتركنا نهبًا للسنوات تأكل من ذواتنا قضمة بعد إخرى إلى أن تشوِّهَنا؟
هل نحن بحاجة لإعادة النظر في تفسيرات دينية واجتماعية في لحظتنا المعاصرة، أقوال تصف وتخص المرأة وتتردد على أفواه الجميع من قبيل: “ناقصات عقل ودين”، “خُلقن من ضِلع أعوج”، “اضربوهن واهجروهن في المضاجع” و”إذا دعا الرجُل امرأته إلى فِرَاشه فلمْ تأتِه، فبات غضبان عليها؛ لعنتها ملائكته حتى تصبح”، أو “لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لإحد؛ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها” أو “لن يفلح قوم وَلَّوا أمرهم امرأة”، هذه الأسئلة التي أثَرْتُها مِرَارًا في مقالات سابقة، والتي أثيرت الأيام الماضية على نطاق واسع بعد عرْض مسلسل “فاتن أمل حربي”.
لعلنا جميعًا لاحظنا احتقان الرأي العام في المجتمع المصري، وجنوحه نحو التعاطي بعنف مع كل رأي يختلف عمَّا اعتاده، حيث رسَّخ له الخطاب الاجتماعي والديني طويلًا، فكلَّما أثيرت إحدى القضايا – التي يكتبها التنويريون، وتُعالَج دراميًّا أو إعلاميًّا، ويتم من خلالها إعادة النظر في بعض المفاهيم الراسخة لدى الجموع، أو طرْح متجدِّد يُناقِش بعض الآراء الموروثة في التراث والثقافة العربية والإسلامية، وتقديم رؤية مختلفة لذات القضايا، منظور معاصر يعتمد على العقلانية، ويراعي حقوق المرأة ككيان إنساني غير منتقَص في الحقوق والواجبات – كلَّما ثار الرأي العام، واعترضت بعض المؤسسات بطريقة عدائية تجنح للترهيب والحَط من أي اجتهاد، أو رؤية أخرى تشمل مناظير إنسانية لمعالجة بعض موروثاتنا، التي تعتمد على اجتهاد العلماء في عصور ماضية، هذا الاحتقان والرفض وتكفير المختلِف، دون فتْح حالة من النقاش والثقة في اجتهاد العقل البشري، ومنجَز الحضارة العالمية، ودون النظر للَّحظة التاريخية التي نعاصرها، وما اكتنفها من تحولات تخص شأن المرأة، هذا العداء للعقلانية لن يجعلنا نترك أو نبارح أماكننا، أوضاعنا التي يكتنفها الغبن والجور على الكثير من حقوق المرأة.
إن خطاب الإصلاح والتنوير لا يمكنه أن يجد مسارًا في الوعي الجَمْعي لمجتمعاتنا العربية في ظِلِّ هذا التردِّي الثقافي، واستقواء السلطة الدينية، بتياراتها التي ترفع شعار: لا اقتراب ولا مساس بأيِّ موروث مهما تنافَى مع العقلانية.